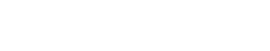قانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء
– بعد الاطلاع على الدستور، – وعلـى المـرسـوم بالقـانون رقـم (67) لسـنة 1980 بإصـدار القـانـون المـدنـي، المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996، – وعلـى القـانـون رقـم (50) لسـنة 1994 في شـأن اسـتغلال القسـائم والبيـوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2008، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه […]